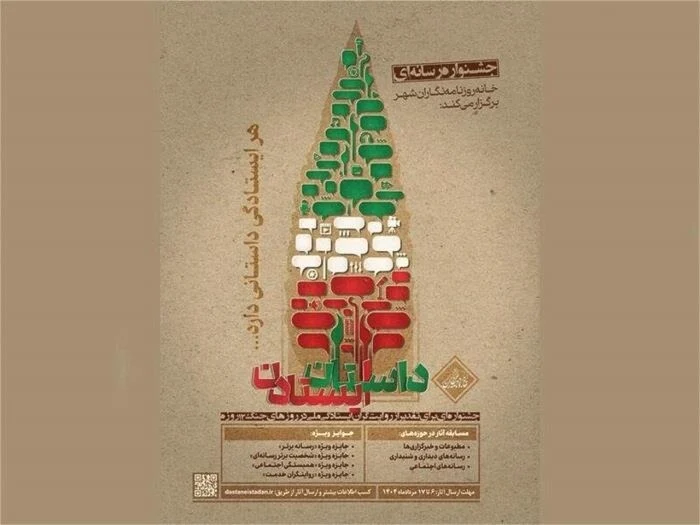بواسطة akhbariran | آب 4, 2025 | أمن وسلاح, سياسة
مقدمة:
في 13/6/2025، شرعت “إسرائيل” بهجوم عسكري على أهداف إيرانية، خصوصاً المنشآت النووية وبعض الوحدات العسكرية التابعة للحرس الثوري والجيش الإيراني. وتمكنت “إسرائيل” في الأيام الأولى من اغتيال عدد من القادة العسكريين، وعدد آخر من نخبة علماء المجال النووي في إيران. وفي يوم 22/6/2025، شاركت الولايات المتحدة في الهجوم على ثلاثة مرافق نووية إيرانية (فوردو Fordow، وناتنز Natanz، وأصفهان Isfahan). ثم تمّ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الأطراف بعد يومين من المشاركة الأمريكية.
وادَّعت الأطراف المتصارعة تحقيق انتصارات في تلك المواجهة، واتّجه التقييم الأمريكي، من خلال الرئيس دونالد ترامب Donald Trump وبعض العسكريين الأمريكيين، إلى القول بأنّ المشروع النووي الإيراني قد “تمّ تدميره”.[2] وادَّعت “إسرائيل” أن الخسائر الإيرانية كانت كبيرة في برامجها النووية، وفي دفاعاتها الجوية، ومصانع صواريخها، وفي نخبتها العلمية.[3] بينما ادَّعت إيران، على لسان مرشدها الأعلى علي خامنئي Ali Khamenei، والعديد من قادتها العسكريين، أنّ إيران انتصرت على خصومها، وأن الخسائر الإسرائيلية أكبر مما يتم الاعتراف به، خصوصاً الضربات التي وُجّهت إلى مناطق في تل أبيب، وبعض المؤسسات الأمنية، والمرافق العلمية مثل معهد وايزمن Weizmann Institute وجامعة بن جوريون Ben-Gurion University ، ومصافي البترول في حيفا، ومقار بعض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية،[4] وهو ما توالى الاعتراف الإسرائيلي به بعد أيام من المواجهة. [5]
فرضت هذه المواجهة عدّة أسئلة نسعى للإجابة عليها من خلال التركيز على التقييمات التي نشرتها مراكز الدراسات “غير العربية”، ومحاولة استخلاص الأسباب والنتائج والتداعيات المستقبلية لهذه المواجهة على المكانة الإقليمية لإيران. وقد سعينا لتنويع هذه المراكز من أمريكا وأوروبا وآسيا، مع اختيار المراكز التي تناول كلٌّ منها بُعداً متميّزاً في المواجهة موضوع الدراسة، ثم حاولنا تحديد نقاط التوافق والتباين بين هذه المراكز للتعرّف على التداعيات المستقبلية لما جرى.
ومن الضروري أن نحدّد في هذه المقدّمة مفهوم “المكانة الإقليمية” لأيّ دولة، وتحديداً مفهوم “الدولة المركز للإقليم Core Country”، إذ يُعرّف الاتحاد الأوروبي للأبحاث السياسية European Consortium for Political Research القوة الإقليمية بأنّها “دولة تنتمي إلى منطقة جغرافية محددة، تُهيمن على هذه المنطقة اقتصاديّاً وعسكريّاً، وقادرة على مآذارة نفوذها في المنطقة، ومعترف بها أو حتى مقبولة كقائدة إقليمية من قِبل جيرانها”. بينما يعرّفها المعهد الألماني للدراسات العالمية والإقليمية German Institute of Global and Area Studies (GIGA) بأنّها الدولة القادرة على أن تآذار تأثيراً حاسماً على الامتداد الجغرافي لإقليمها، وعلى بنيته الأيديولوجية وأجندته الأمنية، من خلال التفوّق في القدرات، ويُقرّ لها أعضاء الإقليم والقوى الدولية بهذا الدور.[6] ومعلوم أنّ إيران وضعت سنة 2005 خطة استراتيجية لجعلها دولة مركزية إقليمية، خصوصاً لإقليم غرب آسيا الذي يمثّل الشرق الأوسط الجزء الأساسي منه.[7]
أولاً: أسباب ونتائج الهجمات الأمريكية الإسرائيلية:
من المعلوم أنّ العلاقات الإيرانية مع كلٍّ من “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية هي علاقة صراعية منذ سنة 1979، كما أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية هي علاقة استراتيجية تقوم على إحباط السعي الإيراني لأن تكون إيران “مركز الإقليم”، كما ورد في الخطة الإيرانية. وهو ما يعني أنّ الهجوم الأخير على إيران ليس إلّا حلقة من حلقات هذا الصراع.
ولمنع إيران من تحقيق خطتها، وضعت الولايات المتحدة الأمريكية و”إسرائيل” ثلاثة أهداف، هي:
1. تغيير النظام السياسي في إيران.
2. منع إيران من إنجاز برنامجها النووي.
3. إفشال المساعي الإيرانية لتكون الدولة المركز في الإقليم.
ذلك يعني أنّ الهجوم العسكري الأمريكي الإسرائيلي في سنة 2025 على إيران كان يسعى لتحقيق هذه الأهداف أو بعضها على أقل تقدير. فهل كانت النتائج متوافقة مع الأهداف؟
هذا ما سنحاول تقييمه من خلال عرض تقييمات أكاديمية مختلفة للنتائج، لنعمل على بناء تصوّر مستقبلي للمكانة الإقليمية الإيرانية، استناداً إلى ما توافقت عليه أغلب هذه التقييمات.
ثانياً: التقييم الأمريكي للنتائج:
في تقييمٍ لنتائج الهجوم الأمريكي الإسرائيلي وتداعياته المستقبلية، يرى مركز كارنيجي الأمريكي Carnegie Endowment for International Peace ا[8] ضرورة التمييز بين بُعدين في المواجهة الأخيرة، هما: تدمير البنية التحتية من ناحية، وتدمير القدرات من ناحية ثانية للبرنامج النووي الإيراني. فالعمل العسكري يمكنه تدمير المعدات والمنشآت، لكن ذلك لا يمتد إلى القضاء على المعرفة أو المرافق الموزعة على نطاق واسع، خصوصاً في دولة تتجاوز مساحتها نحو 1.648 مليون كم2، أو إلغاء الدوافع الاستراتيجية الكامنة وراء تطوير الأسلحة النووية. ويبدو أن إيران، وطبقاً لتواتر تقارير مختلفة، تمكّنت من نقل موادها الأكثر حساسية (يجري الحديث عن مئات الكيلوجرامات من اليورانيوم المُخصّب) قبل الضربات، وهو ما يعني حماية جوهر برنامجها للتخصيب من ناحية، كما أنّ وجود المخابئ السليمة لبعض آلاتها المركزية في المشروع قد يُشكّل نقطة انطلاق لإعادة بناء برنامجها من ناحية أخرى.[9] ويُقدّر تقرير مركز كارنيجي، استناداً إلى صور الأقمار الصناعية والمعلومات الاستخبارية، نتائج الضربات على النحو الآتي:
1. أنّ الضربات على فوردو وناتنز اخترقت المنشآت السطحية وسدّت منافذ رئيسية تحت الأرض. وتكشف هذه الصور لموقع فوردو ستّ حُفر واضحة فوق قاعات أجهزة الطرد المركزي المدفونة، ومن المرجّح أن القنابل الخارقة جي بي يو-57 أو GBU-57، نفذت عبر الصخور إلى قاعات أجهزة الطرد المركزي وغيرها من المناطق الحساسة قبل أن تنفجر، ممّا قد يتسبّب في أضرار جوفية أوسع بكثير ممّا يمكن أن تكشفه الصور السطحية.
2. أمّا في ناتنز، التي تعرّضت بالفعل لهجمات صاروخية إسرائيلية، فقد عانت من دمار إضافي، حيث من المرجّح أنّ الضربات الأمريكية اخترقت مباشرة سلاسل أجهزة الطرد المركزي المتبقية ومناطق البنية التحتية الحيوية. وحتى قبل الضربة الأمريكية، عانت ناتنز من تدمير كامل لبنيتها التحتية الكهربائية، حيث دُمّرت محطات فرعية رئيسية، ومولّدات طوارئ، ومصادر طاقة، مما جعل سلاسل أجهزة الطرد المركزي المتبقية غير صالحة للعمل.
3. في أصفهان، يبدو أن الضرر السطحي الواسع النطاق الظاهر في صور الأقمار الصناعية يُعزى في المقام الأول إلى ضربات إسرائيلية سابقة، قضت على منشأة إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم uranium hexafluoride الرئيسية في إيران، وقدرات إنتاج معدن اليورانيوم uranium. بينما استهدفت صواريخ توماهوك Tomahawk الأمريكية ما تبقّى من المجمّع، بما في ذلك مداخل منشآت تخزين اليورانيوم عالي التخصيب تحت الأرض، على الرغم من احتمال أنّ إيران ربما نقلت هذه المواد الحساسة.[10]
وفي تقييم آثار ذلك، يرى تقرير المركز الأمريكي أنّ هذا التدمير المادي للبنية التحتية النووية يُعيق البرنامج الإيراني، لكنه لا يصل إلى نقطة اللا عودة، خصوصاً أنّ مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية International Atomic Energy Agency (IAEA) تحقّقوا آخر مرة من مخزونات المواد النووية الإيرانية قبل أيام قليلة من بدء الضربات الإسرائيلية في 13/6/2025، مما يُثير احتمال أن تكون السلطات الإيرانية قد نقلت بشكل استباقي مخزونات رئيسية من اليورانيوم عالي التخصيب من المنشآت المُعلنة إلى مواقع غير مُعلنة. وهو استنتاج مبني على صور الأقمار الصناعية ليومي 19 و20/6/2025، والتي تظهر فيها شاحنات وجرافات قرب مداخل أنفاق فوردو، وهو ما تمّ تفسيره كدليل على أنّه لجلب التراب لإغلاق بوابات الأنفاق بدلاً من نقل المحتويات من ناحية، كما أنّ وجود شاحنات أخرى مجهولة الهوية يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال نقل المواد من ناحية أخرى.
ويُقدّر التقرير الأمريكي أن نحو 15 ألف جهاز طرد مركزي في ناتنز قد أصبح مُعطّلاً بسبب انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، حيث أكّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود ثُقبين ناتجين عن اصطدام صاروخي فوق قاعات التخصيب المقامة تحت الأرض، مما أدّى، على الأرجح، إلى تلوّث إشعاعي موضعي ومخاطر كيميائية. وهو ما يشير إلى أنّ حجم الضرر قد يحول دون إعادة تشغيل هذه المواقع المتضررة بشدة، ويرجّح التقرير أنّ بناء منشآت جديدة كلياً هو الخيار الأرجح، بدلاً من مجرد حفر الأنفاق وإصلاح ما تدمّر.
أمّا الضرر الذي أصاب البنية التحتية لتحويل اليورانيوم في أصفهان، فإنّ المدى الزمني المطلوب لإعادة الإعمار ما يزال قيد التقييم. وقد استند المعهد الأمريكي إلى تقارير أخرى تُفيد بتدمير وحدة، ما تزال قيد الإنشاء، لمعالجة معدن اليورانيوم المُخصّب، والذي يُعدّ على نطاق واسع عنصراً أساسياً في التسلّح النووي. لكن التقرير الأمريكي يرى أنّ عمليات تحويل معدن اليورانيوم الأساسية هي عمليات كيميائية بسيطة نسبياً، ويمكن، من حيث المبدأ، إعادة بنائها بالتوازي مع استعادة التخصيب، مما يحدّ من التأخيرات طويلة الأمد في برنامج أسلحة محتمل.
أما القدرة الايرانية على استئناف برنامجها النووي، فيُشير التقرير إلى عدد من المؤشرات التي ترجّح الإمكانية الإيرانية للاستئناف، وهي:
1. المخزون الكافي لدى إيران من اليورانيوم المُخصّب بمعدل 60%.
2. مخزون إيران من مكوّنات أجهزة الطرد المركزي غير المُركّبة، فقد صنّعت إيران أجهزة طرد مركزي متطوّرة لسنوات لم تخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ انهيار الاتفاق النووي في أيار/ أيار 2018، وهو ما يُمثّل احتياطياً يُسهم في سرعة استئناف البرنامج النووي.
3. على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بمنشآت أبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزي المُقامة فوق الأرض في ثلاثة مواقع (كرج Karaj، ومركز طهران للأبحاث Tehran Research Center، وناتنز)، فإنّ البنية التحتية لأجهزة الطرد المركزي المُقامة تحت الأرض ما تزال، على الأرجح، تعمل.
4. لم تُلغِ الهجمات الأمريكية الإسرائيلية العناصر الأساسية التي دعمت المسار النووي الإيراني، وأهمها:
أ. بنية تحتية واسعة وموزعة.
ب. قاعدة كوادر فنية واسعة.
ج. سلاسل إمداد محلية واسعة.
د. إرادة سياسية واضحة لإنجاز الهدف النووي (البرنامج السلمي المُعلَن). وتعزيزاً لذلك، فقد جرى إضفاء الطابع الرسمي على تحوّل إيران نحو موقف نووي متشدّد، من خلال أدوات قانونية وسياسية مُصمّمة لقطع الرقابة وفرض سيطرة وطنية كاملة. ففي 25/6/2025، أقرّ البرلمان الإيراني، بأغلبية ساحقة، قانوناً يُعلّق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشترطاً موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي على دخول المفتشين في المستقبل. وأوضح عضو هيئة رئاسة البرلمان، علي رضا سليمي Alireza Salimi، أنّ مشروع القانون يحظر دخول مفتشي الوكالة “ما لم يُضمَن أمن المنشآت النووية والأنشطة النووية السلمية للبلاد”، ويفرض عقوبات على أيّ فرد يُسهّل عمليات التفتيش غير المصرّح بها. وتشير نتائج التصويت في مجلس الشورى الإيراني إلى مساندة قوية، تتجلى في تأييد 210 أصوات، وامتناع اثنين فقط عن التصويت. وقد تلا ذلك قرار بوقف السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة التفتيش، دون الانسحاب الإيراني من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ولكن مع التهديد بذلك، إلى جانب موافقة مجلس الوصاية الإيراني على موقف مجلس الشورى، ثم قرار الوكالة بسحب مفتشيها.[11]
5. إنّ غياب إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن المراقبة، يمنح إيران مساحة عملياتية كافية لمواصلة جهود إعادة الإعمار السرّية، بينما يفقد المجتمع الدولي رقابة حاسمة على الأنشطة النووية الإيرانية.
6. مستقبل البرنامج النووي الإيراني: يُحدّد التقرير الأمريكي مستقبل البرنامج استناداً إلى مجموعة من المحددات، هي:
أ. مدى الضرر الذي أصاب البنية الرئيسية للبرنامج، وهو أمر ما يزال غير واضح، وإن كانت التقديرات، كما سنرى، في أغلب التوجّهات تُقدّر الضرر بأنه أكبر ممّا تتظاهر به إيران، لكنه أقل مما ادّعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو Benjamin Netanyahu.
ب. تقييم إيران للتهديدات العسكرية المستمرة، خصوصاً ضدّ الدولة والنظام والبرنامج ذاته؛ فكلما زادت المخاطر في التقدير الإيراني، يكون الاندفاع نحو استعادة البرنامج النووي أقوى وأسرع، ويبدو أن التهديدات ما تزال عالية.
ج. الموارد المتاحة لإيران، وهي مسألة يبدو أنّ المرحلة السابقة تشير إلى أنّ إيران قادرة على تجاوز تعقيدات الحصار عليها بنسبة كافية.
د. إنّ أي خطوات ملموسة نحو إعادة البناء، أو تقليص إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستُرجّح احتمال عودة “إسرائيل”، أو الولايات المتحدة، إلى تنفيذ ضربات استباقية، مما يُعزز فرضية عدم استقرار الوضع الإقليمي في المدى المنظور.
وفي تقرير أمريكي ثانٍ أعدّه معهد دراسة الحرب الأمريكي Institute for the Study of War (ISW)، تمّ التركيز على أربعة جوانب، هي: [12]
1. مدى تضرر البرنامج النووي الإيراني من الضربات الإسرائيلية والأمريكية:
يعتمد التقرير في تناوله لمدى الضرر في البرنامج النووي الإيراني على عدد من المصادر، منها الوثيقة الصادرة عن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية Defense Intelligence Agency، التي قدّرت أنّ أضراراً جسيمة لحقت بمحطة فوردو، لكنّ القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات، التي سدّت مداخل موقعين نوويين، فشلت في هدم مبانيهما الواقعة تحت الأرض.
أما معهد العلوم والأمن الدولي The Institute for Science and International Security (ISIS)، وهو مركز أبحاث لمنع الانتشار النووي، ومعروف باعتنائه بمتابعة البرنامج النووي الإيراني لفترة طويلة، فقد رجّح بشدّة أن تكون الضربات قد دمّرت أو أتلفت معظم أجهزة الطرد المركزي في فوردو، استناداً إلى مواقع التأثير وتأثيرات موجات الانفجار.
وفي المقابل، قدّرت لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية Israel Atomic Energy Commission أنّ الضربة الأمريكية على فوردو دمّرت البنية التحتية الحيوية للموقع، و”جعلت منشأة التخصيب غير صالحة للعمل”.
ويُضيف معهد دراسة الحرب إلى تلك التقارير عرضاً لتسريبات استخبارية وتقديرات من خبراء نوويين، تشير إلى أنّ الضربة الأمريكية أدّت إلى تدمير نحو 20 ألف جهاز طرد مركزي في كلٍّ من فوردو وناتنز، وأنّ القادة العسكريين الإيرانيين قدّموا تقارير مضلّلة إلى قياداتهم السياسية بشأن مدى الأضرار.
ويميل معهد العلوم والأمن الدولي، في تقريره، إلى أنّ إيران نقلت قدراً من اليورانيوم المُخصّب قبل التعرّض للهجوم، لكنّ تخصيب اليورانيوم إلى درجة 60% و90% سيشهد تباطؤاً، خصوصاً أنّ لدى إيران مخزوناً من اليورانيوم المُخصّب بدرجات 3%، و5%، و20%، و60%.
2. دلالات التوقّف عن التعاون الإيراني مع وكالة الطاقة الذرية الدولية:
كرّر المسؤولون الإيرانيون الحديث عن انسحاب إيران من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، واحتمال تعليق عضويتها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفيما بعد، صادق مجلس الشورى الإيراني على القرار بتعليق التعاون، وتبنّته الحكومة. ويرى المعهد أنّ بعض هذه المواقف الإيرانية سبق أن هدّدت بها إيران في مناسبات سابقة. وتشير تقارير الوكالة الدولية إلى أن مستوى التعاون الإيراني مع الوكالة “غير مُرضٍ” بالقدر الكافي.
3. مدى استقرار النظام السياسي بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي:
يشير المعهد إلى أنّ إجراءات النظام الإيراني بخصوص هذا الموضوع تركّزت على ثلاثة أبعاد هي: المناطق الكردية في الشمال الغربي من إيران بشكل أساسي، ونشر قوات على الحدود مع كل من باكستان والعراق وأذربيجان، خوفاً من تسلّل جماعات عسكرية إلى الأراضي الإيرانية، وسلسلة عمليات الاغتيال للقادة العسكريين والعلماء البارزين في الحقل النووي، التي نبّهت النظام الإيراني إلى المخاطر الداخلية، وهو ما دفعه لاعتقال المئات ومصادرة ورشات إنتاج معدات حربية.
4. دور العلاقات الإيرانية الدولية:
يُقدّر المعهد أن رضا إيران عن علاقاتها مع روسيا أقل من درجة رضاها عن علاقاتها مع الصين، إذ يبدو أنّ الدعم الروسي المأمول من قِبَل إيران لم يرقَ إلى مستوى ذلك الأمل، بينما يبدو أنّ الصين أكثر مساندة. فقد وصل وزير الدفاع الإيراني، عزيز ناصر زاده Aziz Nasirzadeh، إلى جمهورية الصين الشعبية في 25/6/2025، في أول زيارة خارجية له منذ أن بدأت “إسرائيل” حملتها الجوية على إيران. وقد شارك ناصر زاده في اجتماعٍ لوزراء دفاع دول منظمة شنجهاي للتعاون Shanghai Cooperation Organization (SCO)، استمرّ يومين في مدينة تشينغداو.
ويميل التقرير إلى أنّ الغاية من الزيارة هي الاستعانة بالصين لإعادة بناء البنية التحتية العسكرية والاقتصادية التي تضرّرت من الحرب، لا سيّما أنّ الصين الشعبية تُقدّم لإيران منتجات عسكرية أو منتجات ذات استخدام مزدوج، كما تُسهم في شحن المواد الأولية اللازمة لدعم تجديد مخزونات الصواريخ الباليستية الإيرانية التي تعمل بالوقود الصلب.
كذلك تُعدّ الصين شريان حياة اقتصادياً بالغ الأهمية لإيران من خلال شرائها نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. ومن المرجّح أن يكون المسؤولون الإيرانيون حريصين على تأمين شراكة اقتصادية مع جمهورية الصين الشعبية في أعقاب الضربات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة.
ثالثاً: المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية:
ركّز المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية French Institute of International Relations (Ifri) تحليله على بُعدين، هما:[13]
1. المعارضة الإيرانية وآفاق عملها المستقبلي:
تركّز تحليل المركز الفرنسي للعلاقات الدولية على ضعف احتمالات عودة النظام الملكي (الشاهنشاهي) تحديداً إلى إيران، ورأى أنّ ولي العهد الإيراني السابق، رضا بهلوي Reza Pahlavi (ابن شاه إيران)، هو أبرز قيادات هذا التيار. لكنّ خلاصة تقرير المركز تصل إلى نتيجة محدّدة، وهي أنّ تفكّك المعارضة الإيرانية، ومحدودية صلة رضا بهلوي بالمعارضة الداخلية في إيران، إضافة إلى أنّ خطابه السياسي يعتمد على مداعبة مشاعر الحالمين بالعودة إلى الحكم المدني أو العلماني كما كان عليه الحال في زمن والده، كلها عوامل لا تُشير إلى نجاح قريب للمعارضة.
2. العلاقات الإيرانية الأذرية:
يرجّح المركز احتمالات تجدّد النزاع الإيراني مع أذربيجان، ويستند هذا الترجيح إلى الخلافات التاريخية حول الأقلية الأذرية في إيران، والتي تُشكّل نحو 16% من السكان، إضافة إلى الموقف الإيراني المُسانِد لأرمينيا في الصراع الأرمني الأذري. كما أنّ العلاقات الإسرائيلية المتطوّرة مع أذربيجان تُشكّل نقطة قلق كبيرة لإيران.[14]
رابعاً: موقع “تفكير الصين” ThinkChina:
ترى إحدى دراسات الموقع السنغافوري موقع “تفكير الصين” ThinkChina، المتخصص في الشأن الصيني، والذي يعتمد في العديد من دراساته على عدد من الباحثين الصينيين المرموقين،[15] أنّ المواجهة الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة ضدّ إيران كشفت عن مجموعة من الدلالات التي تُسهم في تحديد احتمالات التوجّه الإيراني مستقبلاً، وذلك على النحو الآتي:
1. كشفت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية عن ثغرة تقنية في الدفاعات الإيرانية، التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الروسية، وهو ما قد يغوي إيران للتوجّه نحو الصين، خصوصاً في مجال الدفاع الجوي، لا سيّما بعد النتائج اللافتة للنظر في أداء الدفاعات الباكستانية ضدّ الهند، اعتماداً على التكنولوجيا الصينية، خصوصاً في مجالات الطائرات المُسيّرة، والصواريخ، وأنظمة الإنذار المبكر، والقدرات السيبرانية، وأجهزة المراقبة. ولعلّ ذلك يُوحي بتسارع وتنامي ميادين التعاون الصيني الإيراني على حساب “بعض العلاقات الروسية الإيرانية”.
2. تُشكّل الخبرة الكورية الشمالية مرجعية في التفكير الاستراتيجي الإيراني في المجال النووي، ويتمثّل ذلك في أنّ امتلاك الأسلحة النووية، وإظهار القدرة على استخدامها، يترك أثراً كبيراً على طاولة المفاوضات، يفوق تأثير مجرد وجود الإمكانيات لإنتاج السلاح النووي. ذلك يعني أنّ إيران قد تجد نفسها مضطرة للتخلّي عن استراتيجية الغموض الاستراتيجي، التي لم تمنع الهجوم عليها، وتتجه نحو النموذج الكوري الشمالي، لتضع حدّاً للرغبة في مهاجمتها مرة أخرى.
3. يُواجه الاقتصاد الإيراني المتعثّر ضغوطاً قاسية، فقد ألحقت الحرب أضراراً بالبنية التحتية الحيوية للطاقة، مثل المصافي والموانئ البحرية، مما أدّى إلى تفاقم نقص الطاقة المحلي، واستمرار القيود على المنافذ التقليدية لإيرادات النفط. ولعلّ ذلك يُعزّز فكرة التوجّه نحو الصين، والتي تبدو بوادرها في وصول أول قطار شحن صيني مباشر إلى ميناء أبرين الجاف Aprin Dry Port الإيراني في أواخر أيار/ أيار 2025، كجزء من استراتيجية أوسع لترسيخ دور إيران في مبادرة الحزام والطريق الصينية China’s Belt and Road Initiative (BRI) عبر باكستان وآسيا الوسطى. ويتعزّز هذا التوجّه بأنّ مبادرة الحزام والطريق الصينية، خصوصاً ممرها الغربي عبر باكستان وآسيا الوسطى، توفّر لإيران عدداً من المزايا، مثل: تمويل البنية التحتية، والترابط التجاري، وإضعاف نسبي للعقوبات المفروضة عليها. وهو ما يُمثّل نقطة التلاقي بين رغبة صينية في تحقيق الاستقرار السياسي في منطقةٍ مهمّة لمشاريعها الاستراتيجية كمبادرة الحزام والطريق، وبين حاجة إيرانية إلى إيجاد بدائل للمجالات الحيوية التي أقفلها الحصار عليها. ولا شكّ أن ذلك سيُسهم في دمج إيران مستقبلاً في الاقتصاد الأوراسي الأوسع.
4. يبدو أن النزوع البراجماتي الصيني في إدارة العلاقات الدولية ينطوي على بعض المحاذير التي لا بدّ لإيران أن تراعيها. فمع الإقرار بالقوة الصاعدة للصين ودورها في مجلس الأمن لمنع صدور قرارات قد تلحق ضرراً استراتيجياً بإيران، إلا أنّه من الضروري التنبّه إلى أنّ الصين ستميل إلى استراتيجية تقوم على بُعدين هما:
أ. استثمار مواطن المنفعة من العلاقة مع إيران، خصوصاً في اعتبارها بوابة لموارد الطاقة والمعادن، وسوقاً للتوسّع التجاري والاستثماري، ونقطة وصل بين العديد من محاور استراتيجية الصين الأوراسية، ومعبراً جيواقتصادياً إلى الشرق الأوسط، ناهيك عن أنّ التزاحم الإيراني الأمريكي في المنطقة يشكل أداة للصين لصرف انتباه الولايات المتحدة وإشغالها بعيداً عن منطقة المحيطَين الهندي والهادئ، التي تمثل ركناً أساسياً في الاستراتيجية الصينية الكبرى.
ب. بالرغم من النهج البراجماتي الصيني السابق تجاه إيران، إلا أنّه من غير المرجح أن تقدم الصين التزامات دفاعية مشتركة معها أو تنخرط في الصراعات الطائفية أو السياسية أو العسكرية في الشرق الأوسط. كما أنها ستميل إلى قدر من التردُّد في قبول تجاوز إيران لعتبة الأسلحة النووية. ويترتب على المعطيات السابقة صورة تشير إلى أنّ المستقبل الإيراني محفوف بالمخاطر، خصوصاً إذا تمّ استئناف تخصيب اليورانيوم بطريقة توحي باستمرار السعي المفترض نحو التسلح النووي، مما قد يدفع الصين للتردد في مساندة صريحة للسلوك الإيراني.
5. إشكالية مضيق هرمز: نظراً للسيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، لا تستبعد الصين احتمال إغلاق المضيق في حال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. لذلك، وتحسباً من تداعيات هذا الإغلاق، تبنّت بكين استراتيجية استباقية تقوم على ما يلي:
أ. تنويع مصادر الطاقة وعدم الاقتصار على مصادر محددة، وهو ما يتضح في تزايد الاعتماد الصيني على دول نفطية أخرى مثل روسيا، ودول آسيا الوسطى، والبرازيل، وأنغولا، وأستراليا، مع استمرار العلاقة مع إيران.
ب. اعتماد الصين استراتيجية التنويع في هذا الحقل، من خلال إيجاد طرق بديلة لمضيق هرمز مثل خطوط الأنابيب البرية أو الطرق البحرية التي تتجاوز مضيق هرمز تماماً، وهو ما يتجسد في خط أنابيب الغاز بين الصين وآسيا الوسطى، وخط أنابيب النفط بين شرق سيبيريا والمحيط الهادئ، إلى جانب الواردات المتزايدة من الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر القطب الشمالي.
ج. بناء احتياطيات استراتيجية كبيرة، تُقدّر حالياً باحتياطيات تكفي لمئة يوم من البترول ولـ 35 يوماً من الغاز.
د. خفض اعتمادها على النفط المستورد بالنسبة إلى إجمالي استهلاكها من الطاقة، وهو الواضح في تزايد الاعتماد على مصادر طاقة بديلة للنفط، فهي تستورد لحاجتها الطاقوية ما نسبته 18.2% من البترول (70% منه مستورد)، و8.9% من الغاز (40% منه مستورد) من إجمالي الطاقة المستهلكة لسنة 2024.[16]
6. تدرك الصين أنّ مساعيها لاستقرار الإقليم الشرق أوسطي سيتضرر إذا تمّ تغيير النظام في طهران، لكنها وعلى الرغم من إدانة الهجوم الإسرائيلي على إيران، فإنها تميل للتوسط بين الأطراف المتصارعة، وتتجنب الاصطفاف الواضح إلى جانب إيران خصوصاً في المجال العسكري. ويبدو أنّ استراتيجية الوسيط ستَغلُب على الحركة الصينية في المنطقة، وهو ما يتضح في وساطتها بين إيران والسعودية، وبين الفصائل الفلسطينية، وربما بين إيران و”إسرائيل”.
خامساً: معهد بريماكوف الوطني لأبحاث الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية:
يعزو تقييم قدّمته نائبة مدير معهد بريماكوف الوطني لأبحاث الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations الروسي، فكتوريا زورافليفا Victoria Zhuravleva،[17] دوافع المواجهة الأمريكية الإيرانية الأخيرة إلى “دوافع سياسية بشكل أساسي”، إذ إن النتائج المتحققة من الهجوم الأمريكي على المرافق النووية الإيرانية غلب عليها الميل إلى الادعاء بالنصر من قبل ترامب، وذلك “لضرورات شعبية محلياً ودولياً”، مع أنّ ذلك يتناقض مع وعود ترامب لناخبيه في سنة 2024 بأنه رجل “سلام” وبأنه لن يسمح بحملات عسكرية أخرى، وهو ما أسهم في فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. إذ إن أكثر من 60% من الأمريكيين يعتقدون أنّه لا ينبغي جرّ أمريكا إلى الصراع بين إيران و”إسرائيل”. وللتوفيق بين وعوده وسلوكه مع إيران، لجأ ترامب إلى الإشارة إلى أنّ هذه كانت “مجرد عملية محلية صغيرة”، ولن يكون هناك استمرار، مع التركيز على الادّعاء بتحقيق الانتصار، وبأن البرنامج النووي الإيراني قد لحقت به أضرارٌ جسيمة.
لكن زورافليفا ترى أن ترامب استثمر أيضاً توجهات عدائية لدى المجتمع الأمريكي ضدّ إيران، إذ إنّ 61% من الأمريكيين يرون البرنامج النووي الإيراني تهديداً مباشراً لأمن الولايات المتحدة، وينظر 50% من الأمريكيين إلى إيران كعدو، بينما تميل الغالبية، خصوصاً النخبة في الحزبَين الديموقراطي والجمهوري، إلى اعتبار “إسرائيل” حليفاً وشريكاً موثوقاً به في الشرق الأوسط.
وترى الباحثة الروسية أنّ البُعد الانتخابي الأمريكي له دور في رسم صور متعددة للهجوم على إيران، فعلى الرغم من المظاهرات المساندة للفلسطينيين، خصوصاً من التيار التقدمي الديموقراطي، إلا أنّ موضوع العلاقة مع “إسرائيل” له حساسية خاصة ويتجاوز النزوع الأمريكي الشعبي نحو تغليب المصالح الفردية.
ويحدد تقييم الباحثة الروسية مجموعة من الشواهد التي لا بدّ من رصدها، لأنها تبدو مرجّحة، مثل:
1. احتمال استئناف إيران برنامجها النووي خلال فترة قصيرة.
2. احتمال عودة أمريكا للعمل العسكري ثانية ضد إيران.
3. محاولات الديموقراطيين، وبعض الجمهوريين، تعزيز ربط الحرب بموافقة الكونجرس Congress، ونتائج العملية العسكرية على إيران ستؤثر على الحزب الجمهوري، سلباً أم إيجاباً، أكثر من تأثيرها على ترامب نفسه الذي لن يستطيع الترشح لمرة ثانية.
سادساً: معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي:
تناول معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي Institute for National Security Studies (INSS) في أحد تقاريره العلاقات الصينية الإيرانية،[18] ولكن برؤية تُخالف ما عرضناه من تصورٍ لمعهد دراسة الحرب الأمريكي. ويتضح ذلك في تقرير للمعهد يشير إلى أنّ الصين، تحت قيادة شي جين بينغ Xi Jinping، طرحت سلسلة من المبادرات العالمية التي يمكن أن تساعد في تلمّس الدور الصيني الدولي مستقبلاً. كانت أولى هذه المبادرات هي “الحزام والطريق”، تلتها في السنوات الأخيرة مبادرة التنمية العالمية Global Development Initiative (GDI) سنة 2021، ومبادرة الأمن العالمي Global Security Initiative (GSI) سنة 2022، ومبادرة الحضارة العالمية Global Civilization Initiative (GCI) سنة 2023. وتُعدّ هذه المبادرات، إلى جانب مفهوم “مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية”، جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل البيئة الدولية وتعزيز الرؤية الصينية للنظام العالمي.
لكن التقرير يشير إلى أنّ “إسرائيل” تواجه، في ظلّ هذه الرؤية، سلسلة من الإشكاليات، هي:
1. النفوذ الإقليمي: تُشير رعاية الصين للتقارب الديبلوماسي بين إيران والسعودية، إلى جانب مشاركتها في القضية الفلسطينية بموجب مبادرة الأمن العالمي، بما في ذلك جهود الوساطة بين الفصائل الفلسطينية، وإن كانت رمزية إلى حدّ كبير، إلى تنامي المشاركة الصينية في قضايا حساسة لـ”إسرائيل”، وهو ما ينبغي على “إسرائيل” تقييم مدى تأثيره على التوازن الاستراتيجي الإقليمي وانعكاساته على الأمن الإسرائيلي.
2. تصاعد التنافس بين الكتل الدولية الكبرى: تُعزز المنافسة بين الولايات المتحدة والصين نظاماً دولياً أكثر استقطاباً، يتميز بتصاعد التوترات والخلافات في المحافل العالمية، وهو ما يجعل عملية صنع القرار في “إسرائيل” أكثر تعقيداً، خصوصاً فيما يتعلق بقدرتها على الحفاظ على هامشٍ للمناورة باستقلالية في مجالات مُعيّنة، إضافة إلى قدرتها على طرح أجندات جديدة على الساحة الدولية تخدم الاستراتيجية الإسرائيلية.
3. الضغط الأمريكي: يجب على “إسرائيل” التوفيق بين تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ودور الصين كشريك تجاري مهم، فمن المُرجّح أن يشتد الضغط الأمريكي، ولا سيّما فيما يتعلق بالاستثمارات الصينية في “إسرائيل” في البنية التحتية الحيوية والتقنيات المتقدمة ذات الاستخدام المزدوج، نظراً للمخاوف الأمنية والاستخباراتية.
في ظلّ هذا المنظور الإسرائيلي للتوجه الصيني، فإنها تربط بين هذا التوجه وبين البرنامج النووي الايراني، ومن هنا يُقدّم المعهد تصوراً[19] لنتائج المواجهة الأخيرة على احتمال استئناف البرنامج الإيراني من ناحية، وانعكاسات ذلك لاحقاً على الدور الصيني من ناحية ثانية.
يشير تقرير المعهد إلى أنّ الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ألحقت أضراراً بالغة بمعظم البنية التحتية لإنتاج المواد الانشطارية في إيران، لكنها لم تصل إلى مستوى التدمير الكامل. وقد تعرضت قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم لخطر كبير، باستثناء موقع فوردو. ومن المتوقع أن يستغرق التعافي من الآثار الأولية عدة أشهر، على الرغم من التأكيد على أنّ البنية المعرفية (العلماء) والبنية التحتية المادية للبرنامج قد تعرضتا لأضرار جسيمة. ويتوقع التقرير أن تقوم إيران بنقل ورش عمل إضافية إلى منشآت تحت الأرض، مع زيادة إنتاج الطاقة في المواقع الثانوية، وتوزيع فرق التطوير على مواقع متعددة. وستحرص “إسرائيل”، في استراتيجية تعطيل النشاط في البرنامج النووي، على تجنُّب استهداف منشآت فعالة خطرة، مع المحافظة على سردية “الاستهداف الدقيق”، وتخدم باتجاه إضعاف مخاطر التدخل الفوري للقوى العالمية، ومن بينها الصين وروسيا.
لكن التقرير يشير إلى إشكالية تتعلق بوكالة الطاقة الذرية الدولية، إذ إنّ من المرجح أن تؤدي الهجمات المستمرة إلى تعطيل قدرة الوكالة على مواصلة عمليات التفتيش في المواقع النووية الإيرانية. وقد تحاول إيران أيضاً نقل القدرات المتبقية إلى مواقع سرية خارج نطاق إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ذلك يعني أنّ السياسة الإسرائيلية تتجه نحو الاستمرار في تعطيل البرنامج النووي الإيراني من جهة، ومن جهة أخرى تجنّب دفع المواجهة إلى الحد الذي يُلزم الشركاء الاستراتيجيين لإيران بالتدخل لكبح السياسة الاسرائيلية.
سابعاً: المؤشرات العامة للتقارير:
أشرنا في بداية هذا التقرير إلى ثلاثة محاور مركزية تتعلق بمستقبل إيران وانعكاساتها على مكانتها الإقليمية والدولية. وسنحاول، استناداً إلى التوجهات المشتركة في الأدبيات غير العربية، إلى تحديد السيناريو الأرجح لإيران على النحو التالي:
تغيير النظام السياسي في إيران:
يمثّل انهيار النظام السياسي في إيران، في ضوء تداعيات الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، هدفاً مركزياً لكل من “إسرائيل” والولايات المتحدة. وقد تبنّت بعض القوى الإيرانية هذا التوجه استناداً إلى المعطيات التالية:[20]
1. الاستناد إلى تصريحات ما يُطلق البعض عليه “ولي العهد الإيراني” وأحد أركان المعارضة الإيرانية في المنفى، رضا بهلوي (ابن شاه إيران السابق)، والتي قال فيها: “طبقاً لمصادر داخل إيران، فإنّ بنية القيادة والسيطرة في النظام تنهار بشكل متسارع، كما أنّ المجتمع الدولي بدأ يدرك بشكل متزايد بأنّ الجمهورية الإسلامية لا مستقبل لها، وهو ما دفع للبدء بمناقشة ما بعد الجمهورية الإسلامية”. ويبدو أنّ هذا التقييم الصادر عن معارض إيراني يأتي بعيداً إلى حدّ كبير عن التقييمات الموضوعية التي تطرحها مراكز الدراسات الأكاديمية.
2. ثمة ستة سيناريوهات تمثّل احتمالات متعددة لمستقبل النظام الإيراني، نحددها في الآتي ثم نبحث مآلاتها:
أ. سيناريو وقوع شقاق بين الحرس الثوري والجيش، وأن يميل بعض قادة الحرس إلى توجهات تذمر أعمق موجودة في الجيش، ويتم تغيير النظام من خلال هذا التحالف بين الجيش والمتذمرين في الحرس الثوري.
ب. سيناريو استعادة بعض قادة المعارضة المحلية الذين أفرج عنهم النظام مؤخراً لدورهم السابق، والعمل على تنظيم صفوفهم واستقطاب الشارع الإيراني مجدداً، من خلال توظيف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحريك الشارع بهدف تغيير النظام.
ج. سيناريو “الحنين إلى الماضي” (النوستالجيا nostalgia)، أي إلى فترة العهد الملكي، وهو أمل تسانده نخب محلية وتدعمه قوى إقليمية ودولية.
د. سيناريو رابع يتمثل في تحالف بعض الأقليات أو أغلبها مع المعارضة الفارسية لتغيير النظام، وقد تكون أهم هذه الأقليات في هذا المجال هي الأقليات الأهوازية أو البلوشية أو الأذرية أو الكردية، لكن المشكلة هنا أنّ الفرس (55% من المجتمع) ينظرون إلى هذه الأقليات كحركات انفصالية، وهو ما يعيق التقارب بين هذه الأطراف.
هـ. الخلاف على منصب المرشد للثورة في حالة غياب خامنئي عن المسرح السياسي الإيراني.
و. بقاء النظام، ولكن هل يعني البقاء مواصلة التوجه الحالي، أم النزوع نحو صبغة عسكرية أكثر، أو صبغة دينية أكثر تشدداً؟
ثامناً: السيناريوهات المستقبلية بين المنظور الإيراني والواقع الحالي:
في تقرير لأحد مراكز الدراسات الإيرانية، تمّ نشره قبل العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران بنحو شهرين،[21] حول سياسات ترامب في ولايته الثانية، يتبيّن وبشكل لا لبس فيه أنّ العقل الاستراتيجي الإيراني لم يكن مطمئناً بأي شكل لسياسات ترامب في المنطقة. وحدّد التقرير ثلاثة عوامل رأى أنّها هي الحاكمة لسلوك الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، وهي “إسرائيل” خصوصاً سياسات نتنياهو الساعية لشرق أوسط جديد، ثم شخصية ترامب، وثالثها دور المؤسسة السياسية الأمريكية. وينتهي التقرير إلى خلاصة محددة وهي أنّ “سياسات ترامب ستجعل الشرق الأوسط أكثر سوءاً من الجانب الأمني”. ذلك يعني أنّ التَّحسب الإيراني من الوصول إلى نقطة المواجهة لم يكن غائباً، وهو ما يعزز التحوط الإيراني خصوصاً على برنامجهم النووي.
وعليه، فإنّ المكانة الإيرانية ستتحدد استناداً إلى ثلاثة عوامل مركزية تضع أسس سيناريوهات المستقبل وهي:
1. الوضع الداخلي الإيراني:
يمكن تحديد الوضع الداخلي الإيراني حالياً من خلال عدد من المؤشرات على النحو التالي:[22]
أ. معدل الاستقرار السياسي: تراجع المعدل الإيراني من 0.32 سالب سنة 1996 إلى 1.69 سالب سنة 2023، وهي تحتل المرتبة 177 من بين 193 دولة في معدل الاستقرار، وبلغ المعدل العام للاستقرار خلال الفترة 1996-2023 ما يساوي 1.12 سالب.
ب. مؤشر جيني Gini index لقياس عدالة توزيع الثروة: تحتل إيران المرتبة 113 (من بين 193 دولة) بمعدل 35.9، مما يجعلها ضمن عدالة نسبية. والملاحظ أنّ معدل دخل الفرد الإيراني يقلّ قليلاً عن 5 آلاف دولار سنوياً (على أساس القيمة الاسمية وليس القوة الشرائية)، وهي بذلك تحتل المرتبة 55 عالمياً، وعلى الرغم من التراجع في هذا المعدل خلال العقدين الماضيين بمعدل 20%، إلا أنّه عاد للتعافي منذ عامين.
ج. الديموقراطية: سجّل مؤشر الديموقراطية الإيراني معدل 1.96 من عشرة، مما يضعها في المرتبة 154 ضمن النظم السلطوية.
د. مؤشر السلام العالمي Global Peace Index لسنة 2024: سجّلت إيران معدل 2.682 من خمسة، وهو ما يضعها في المرتبة 133 عالمياً، بينما احتلت “إسرائيل” المرتبة 155 بمعدل 3.115.
هـ. المركز العلمي طبقاً لعدد العلماء ومعدل النشر العلمي: تحتل إيران مركزاً متقدّماً في هذا الجانب، فهي تقف في المرتبة 15 عالمياً في النشر العلمي، والمرتبة 23 في عدد العلماء.
و. نسبة الإنفاق العسكري إلى إجمالي الناتج المحلي: تصل النسبة الإيرانية إلى 2% (قيمة الإنفاق هي 7.9 مليار دولار)، وتحتل المرتبة 34 عالمياً (مقابل إنفاق إسرائيلي يصل إلى 8.8% بإجمالي 46.5 مليار دولار، مما يضعها في المرتبة 12 عالمياً، ولكنها الأولى في نسبة الإنفاق إلى إجمالي الناتج المحلي).
ز. العولمة: تحسّن مؤشر العولمة الإيراني بالتقدّم عشر مراتب خلال الفترة من 2000–2022، مع الملاحظة أنّ العولمة السياسية (مزيد من الانخراط في النشاطات الدولية) تزايدت، بينما كانت العولمة الاقتصادية هي الأضعف.
وتكشف المؤشرات البنيوية السابقة عن أنّ المؤشرات ذات الطابع السياسي تميل بشكلٍ لا لبس فيه نحو السلبية، بينما يسير مؤشر التطوّر العلمي بشكلٍ إيجابيٍّ واضح، ويتراوح المؤشر الاقتصادي والعسكري بين البُعدين السابقين.
وثمّة بُعدٌ آخر هو مرحلة ما بعد المرشد الحالي خامنئي؛ فهو في عمر 86، أي يفوق معدّل العمر في إيران بنحو 11 عاماً، ولا يتّضح حتى الآن من هو خليفة خامنئي. ويبدو، طبقاً لبعض التقارير، أنّ المنافسة ستكون بين مجتبى خامنئي Mojtaba Khamenei (ابن المرشد) وبين حسن الخميني Hasan Khomeini (حفيد الخميني)، دون استبعاد آخرين مثل صادق لاريجاني Sadegh Larijani (رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام)، أو محسن آراكي Mohsen Araki (من أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام)، أو علي رضا أعرافي Alireza Arafi (رجل دين ورئيس سابق لجامعة المصطفى).[23]
ذلك يعني أنّ الوضع الإيراني قد يميل لبعض الاضطرابات الداخلية أو وقوع اختراقات خارجية لبعض الجماعات الداخلية، كما تبيّن من الاعتقالات الأخيرة في صفوف بعض المجموعات، لكنّ تغيير النظام بالمعنى الذي تسعى له “إسرائيل” والولايات المتحدة ليس مرجّحاً في المدى الزمني المباشر (من 1–3 أعوام)، ويعزّز ذلك:
أ. الرُّشد الذي أبدته المعارضة الإيرانية من داخل النظام، خصوصاً من التيار الإصلاحي؛ فهي تعاملت مع الأزمة على أساس حقّ إيران في التقنية النووية من ناحية، واعتبار التدخّل الخارجي خطراً على البلاد لا على النظام فقط من ناحية ثانية. كما أنّ تفكّك المعارضة ووجود خلافات قومية وآيديولوجية فيما بينها من جانب، ودور الحرس الثوري وقوّات الباسيج Basij في الضبط الداخلي من جانب آخر، يثير شكوكاً حول قدرة المعارضة على الحركة الفاعلة.[24]
ب. حذر الدول الخليجية من انكشاف أيّ دور لها لتعزيز عدم الاستقرار في إيران، وهو أمر قد يُقلِّص من نشاط المعارضة.
ج. أنّ المواجهة تتمّ مع عدوَّين لا يحظيان بصورة إيجابية لدى الشارع الإيراني، خصوصاً “إسرائيل” أولاً، ثم أمريكا.
د. رغبة القوى الدولية، خصوصاً أوروبا والصين وروسيا، بلجم آثار الاضطراب على الأسواق النفطية، خصوصاً إذا اتجهت إيران لإغلاق مضيق هرمز، أو تصاعد القتال إلى حدّ ضرب مؤسسات بترولية في منطقة الخليج كلّها، ممّا يعني الحرص على لجم الاضطراب الداخلي.
هـ. أنّ القدرة الإيرانية على الردّ وإلحاق خسائر مهمة في الجانب الإسرائيلي تتكشّف تباعاً، ما عزّز الشعور بالثقة لدى أنصار النظام، على الرغم من الخروقات الأمنية في بداية المواجهات.
2. البرنامج النووي الإيراني:
يمكن القول إنّ الضرر الذي أصاب البرنامج الإيراني، طبقاً لأغلب التقارير المتداولة، بما فيها تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية،[25] هو “أكبر ممّا تُقِرّ به إيران، لكنه أقلّ كثيراً من الادّعاءات الأمريكية والإسرائيلية”. وطبقاً لمؤشرات التطوّر العلمي التي أشرنا إليها، فإنّ القدرة الإيرانية في البرنامج النووي أصبحت إحدى مسلّمات هذا الميدان، وهو ما يعني أنّ احتمال تراجع النظام الحالي عن برنامجه النووي سيبقى شبه منعدم، وسيبقى الغموض الاستراتيجي هو المُهيمِن على الموقف الإيراني من البرنامج النووي وحدوده. ويبدو أنّ السرّية في البرنامج ستزداد، خصوصاً مع تعليق العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن لا يبدو، حتى الآن، أنّ إيران ستذهب إلى الانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ولكن قد تستخدم هذا الاحتمال من باب الضغوط التفاوضية. مع ضرورة الإشارة إلى أنّ معاهدة سنة 1968 لا تسمح لغير الدول الـ 191 الموقّعة عليها بامتلاك السلاح النووي. ذلك يعني أنّ الاحتمال الأرجح هو أن تستمرّ إيران في برنامجها النووي ضمن استراتيجية الغموض، وهو ما يُبقي احتمال تكرار الهجمات الإسرائيلية والأمريكية عليها قائماً، ما لم يُفاجئ ترامب العالم بتحوّل جديد مع إيران. [26]
3. بنية التحالفات الدولية الإيرانية:
أشرنا إلى أنّ أهمّ حلفاء إيران هما الصين وروسيا، ويبدو أنّ كلاً من هاتين الدولتين تميلان إلى دفع إيران نحو “بعض المساومة”، خصوصاً في برنامجها النووي، على الرغم من الإدانة للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران. فالمنهج الصيني البراجماتي يعزّز ذلك، كما أنّ احتمالات المواجهة حول تايوان تحول دون النزوع الصيني للغرق في المستنقع الشرق أوسطي. أمّا روسيا، فإنّ الانشغال بالجبهة الأوكرانية سيجعلها أقلّ نزوعاً للتمدّد الزائد، بتعبير بول كيندي Paul Kennedy، لكنّ الدولتين لن تبخلا ببعض الدعم السياسي واللوجستي في مجالات معيّنة إذا تصاعد الموقف، خصوصاً أنّ كلاً من الصين وروسيا لهما مصالح مع “إسرائيل” تسعيان لعدم التضحية بها ضمن ظروف معيّنة. كما أنّ اتفاقات الدولتين بالشراكة الاستراتيجية مع إيران لا تصل إلى حدود التحالف العسكري، بل تبقيان في حدود التعاون والتنسيق الأمني والدفاعي.[27]
أمّا في الجانب الإقليمي، فقد تراجعت تحالفات إيران الإقليمية بخسارتها لسورية أوّلاً، وتراجع حزب الله تراجعاً استراتيجياً ثانياً، ثمّ الغموض والتأرجح في القوى العراقية ذات العلاقة مع إيران. فإذا أضفنا إلى ذلك التعاون الكبير بين “إسرائيل” وأذربيجان والهند، يتبيّن أنّ المركز الإقليمي لإيران لن يتحقّق طبقاً لخطّة 2005، لكنّ النظام لن يتخلّى عن هذا التوجّه، وهو ما يزيد من احتمالات عودة المواجهات العسكرية والتطويق المتبادل بين “إسرائيل” وإيران مرّة أخرى.
لكنّ الضرورة تقتضي التنبّه إلى أنّ إيران تنتمي إلى أربعة أقاليم فرعية، هي: الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، والقوقاز، ومنطقة الخليج. وتشير دراسة كرونولوجيا chronological study النزوع الاستراتيجي الإيراني تاريخياً، منذ مرحلة ما قبل حضارة إيلام (3200 ق.م – 2800 ق.م) إلى المرحلة الحالية، إلى أنّ هذا النزوع نحو القفقاس كان 15 مرّة، والشرق الأوسط 13 مرّة، وآسيا الوسطى 10 مرّات، بينما كان النزوع نحو منطقة الخليج مرّتين،[28] أي أنّ المجال الحيوي لإيران يتمركز حول المنطقة الأولى والثانية، وهو ما يجعل إيران متمسّكة بتوجّهها الشرق أوسطي نظراً لحيويته في مجال المكانة الدولية لها.
الخلاصة:
يتّضح لنا من العرض السابق النتائج الأوليّة التالية:
1. ما تزال احتمالات بقاء النظام أعلى من احتمالات تغييره في المدى القصير.
2. احتمالات السعي الإيراني لمواصلة برنامجها النووي أقوى من احتمالات التخلي عنه.
3. إنّ احتمالات غزو أمريكي لإيران ما تزال ضعيفة، في ظلّ معارضة داخلية، وتكلفة ذلك في ظلّ سياسات ترامب، إلى جانب عدم وجود رغبة أوروبية بالمشاركة فيه، ناهيك عن المعارضة الروسية والصينية، وتخوّف دول الخليج العربي من تداعيات ذلك عليها.
4. ما تزال معوّقات بلوغ إيران حالة “الدولة المركز” لإقليم الشرق الأوسط أقوى من محفّزات بلوغه.
5. إنّ احتمالات استمرار الصراع الإسرائيلي الأمريكي مع إيران (عسكرياً، واستخباراتياً، وسياسياً، واقتصادياً) تفوق احتمالات التسوية بينهما، كما أنّ احتمالات استمرار التطويق المتبادل بين “إسرائيل” وإيران (عبر التحالفات الإقليمية مع الدول أو ما دون الدول) تفوق احتمالات التخلي عن هذه الاستراتيجية، لكنها لن تصل إلى الغزو المباشر كما أشرنا.
6. إنّ المؤشرات السياسية لإيران (معدّل الاستقرار، والديموقراطية،…إلخ) تتّسم بالسلبية، بينما تتّسم المؤشرات العلمية بالإيجابية العالية، وتتراوح المؤشرات الاقتصادية بينهما، وهو ما يعني احتمال ظهور بعض مظاهر الاضطراب العابرة بين الحين والآخر.
الهوامش:
[1] خبير في الدراسات المستقبلية والاستشرافية، أستاذ في قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك في الأردن سابقاً، حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وهو عضو سابق في مجلس أمناء جامعة الزيتونة في الأردن، وجامعة إربد الأهلية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للإعلام. ألَّف 37 كتاباً، يتركز معظمها في الدراسات المستقبلية من الناحيتين النظرية والتطبيقية، ونُشر له نحو 120 بحثاً في المجلات العلمية المحكّمة.
[2] Trump claims Iran’s nuclear capabilities ‘obliterated’ despite UN watchdog comments – as it happened, The Guardian newspaper, 25/6/2025, https://www.theguardian.com/world/live/2025/jun/25/israel-iran-war-live-iranian-nuclear-program-could-restart-in-months-pentagon-finds-as-fragile-ceasefire-holds
[3] François Diaz-Maurin, Israel claims it damaged Iran’s Natanz nuclear facility “significantly.” But questions remain, site of Bulletin of the Atomic Scientists, 13/6/2025, https://thebulletin.org/2025/06/israel-claims-it-damaged-irans-natanz-nuclear-facility-significantly-but-questions-remain
[4] Aleksandar Brezar, Iran’s ayatollah claims ‘victory’ over Israel in first public appearance since ceasefire deal, site of Euronews, 26/6/2025, https://www.euronews.com/2025/06/26/irans-ayatollah-claims-victory-over-israel-in-first-public-appearance-since-ceasefire-deal
[5] Amy Spiro, These are the 28 victims killed in Iranian missile attacks during the 12-day conflict, site of The Times of Israel, 29/6/2025, https://www.timesofisrael.com/these-are-the-28-victims-killed-in-iranian-missile-attacks-during-the-12-day-conflict; and Ruti Levy, ‘Turns Out You Can Even Kill Cadavers’: Inside the Scientific and Financial Catastrophe Iran Left in Israel, Haaretz newspaper, 2/7/2025, https://www.haaretz.com/israel-news/2025-07-02/ty-article-magazine/.premium/turns-out-you-can-even-kill-cadavers-the-scientific-catastrophe-iran-left-in-israel/00000197-caec-d78d-a39f-dbfc22500000
[6] Martin Beck, “The Concept of Regional Power: The Middle East as a Deviant Case?,” Conference Paper, “Regional Powers in Asia, Africa, Latin America, the Near and Middle East”, GIGA German Institute of Global and Area Studies, Hamburg, 11-12/12/2006, https://web.archive.org/web/20090327080130/http://www.giga-hamburg.de/content/forumregional/pdf/giga_conference_RegionalPowers_0612/giga_RegPowers0612_paper_beck.pdf
[7] حول تفاصيل هذه الخطة الإيرانية الاستراتيجية في أبعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية، انظر: وليد عبد الحي، إيران: مستقبل المكانة الإقليمية عام 2020 (الجزائر: مركز الدراسات التطبيقية والاستشراف، 2010)، ص 259-261، و548-552.
[8] Nicole Grajewski, The Most Significant Long-Term Consequence of the U.S. Strikes on Iran, site of Carnegie Endowment for International Peace, 26/6/2025, https://carnegieendowment.org/emissary/2025/06/iran-strikes-us-impacts-iaea-nuclear-weapons-monitoring?lang=en&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaczersw1umoTLcATeJ_AOh8SSmUPJNtjaAolMlxqrgBLzAuClI-rvF_VVtxTA_aem_PziIdZwdLj_5XvLArjSOUQ
[9]Strike Set Back Iran’s Nuclear Program by Only a Few Months, The New York Times newspaper, 24/6/2025, https://www.nytimes.com/2025/06/24/us/politics/iran-nuclear-sites.html
[10] Francois Murphy and John Irish, U.S. strikes on Iran’s nuclear sites set up “cat-and-mouse” hunt for missing uranium, Reuters News Agency, 29/6/2025, https://www.reuters.com/world/europe/us-strikes-irans-nuclear-sites-set-up-cat-and-mouse-hunt-missing-uranium-2025-06-29
[11] Francois Murphy, IAEA pulls inspectors from Iran as standoff over access drags on, Reuters, 4/7/2025, https://www.reuters.com/world/middle-east/iaea-pulls-inspectors-iran-standoff-over-access-drags-2025-07-04
[12] Iran Update, June 25, 2025, site of Institute for the Study of War (ISW), https://www.understandingwar.org/backgrounder/iran-update-june-25-2025
[13] Reza Pahlavi, son of king overthrown by Iran’s clerical rulers, sees a chance at regime change, site of The French Institute of International Relations (Ifri), 25/6/2025, https://www.ifri.org/en/media-external-article/reza-pahlavi-son-king-overthrown-irans-clerical-rulers-sees-chance-regime
[14] Sergey Sukhankin, The Caspian Sea as an Emerging Energy Hub : Potentials and Limitations, Ifri, 2/7/2025, https://www.ifri.org/en/papers/caspian-sea-emerging-energy-hub-potentials-and-limitations
[15] Hao Nan, Iran-Israel war: What China won’t do for Iran, site of ThinkChina, 30/6/2025, https://www.thinkchina.sg/politics/iran-israel-war-what-china-wont-do-iran?ref=home-latest-articles
[16] Hao Nan, Strait of Hormuz blockade: Why Beijing is better prepared than you think, ThinkChina, 23/6/2025, https://www.thinkchina.sg/politics/strait-hormuz-blockade-why-beijing-better-prepared-you-think
[17] الصراع في الشرق الأوسط: أمريكا في حيرة وتنتظر النهاية!، موقع إنترفاكس، 27/6/2025، في: interfax.ru/world/1033338 (باللغة الروسية)
[18] Shira Gross, China’s Global Initiatives: Implications and Recommendations for Israel, site of Institute for National Security Studies (INSS), 11/5/2025, https://www.inss.org.il/publication/china-world
[19] Avihum Marom, Spotlight Report: Israeli Strikes on Iran’s Nuclear Sites, INSS, 19/6/2023, https://www.inss.org.il/publication/iran-nuclear-spotlight
[20] Efrat Lachter, Here’s what a post-Ayatollah Iran could look like if war with Israel leads to regime’s fall, site of Fox News, 21/6/2025, https://www.foxnews.com/world/heres-what-post-ayatollah-iran-could-look-like-war-israel-leads-regimes-fall; Erin Cunningham and Mustafa Salim, Clues to the identity of Iran’s next supreme leader in the back alleys of a holy city, site of The Washington Post newspaper, 20/3/2019, https://www.washingtonpost.com/world/clues-to-the-identity-of-irans-next-supreme-leader-in-the-back-alleys-of-a-holy-city/2019/03/20/a96f857e-2a2d-11e9-906e-9d55b6451eb4_story.html; and Parisa Hafezi, Succession plans for Iran’s Khamenei hit top gear, Reuters, 23/6/2025, https://www.reuters.com/world/middle-east/succession-plans-irans-khamenei-hit-top-gear-2025-06-23
[21] Trump’s Middle East Policy Will Be Destructive, site of The Institute for Iran and Eurasia Studies (IRAS), April 2025, https://www.iras.ir/en/trumps-middle-east-policy-will-be-destructive
[22] حول هذه المؤشرات، انظر:
List of countries by number of scientific and technical journal articles, site of Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_scientific_and_technical_journal_articles; Gini index, site of World Bank Group, https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?most_recent_year_desc=true&year=2023; Political stability – Country rankings, site of TheGlobalEconomy.com, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability; Xiao Liang et. al, Trends in World Military Expenditure, 2024, SIPRI Fact Sheet, site of Stockholm International Peace Research Institute (sipri), April 2025, https://www.sipri.org/sites/default/files/2025-04/2504_fs_milex_2024.pdf#page=2; “Democracy Index 2024,” site of The Economist Intelligence, 2025, https://image.b.economist.com/lib/fe8d13727c61047f7c/m/1/609fbc8d-4724-440d-b827-2c7b7300353d.pdf; Global Peace Index 2024: Measuring Peace in a Complex World, site of Institute for Economics & Peace, June 2024, https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2024/06/GPI-2024-web.pdf; and Iran: Overall globalization, TheGlobalEconomy.com, https://www.theglobaleconomy.com/Iran/kof_overall_glob
[23] Parisa Hafezi, Succession plans for Iran’s Khamenei hit top gear, Reuters, 23/6/2025.
[24] Tom O’Connor, As Israel Eyes Regime Change, Iran’s Opposition Is Divisive and Divided, site of Newsweek, 16/6/2025, https://www.newsweek.com/israel-eyes-regime-change-irans-opposition-divisive-divided-2086253
[25] Bill Hutchinson, After US and Israeli strikes, some nuclear experts say Iran could be more dangerous, site of ABC News, 3/7/2025, https://abcnews.go.com/International/after-us-israeli-strikes-nuclear-experts-iran-dangerous/story?id=123224192; Pentagon assesses strikes on Iran’s nuclear program set it back by up to two years, The Times of Israel, 3/7/2025, https://www.timesofisrael.com/pentagon-assesses-strikes-on-irans-nuclear-program-set-it-back-by-up-to-two-years/; Mara Karlin and Fred Dews, How do we know if US strikes on Iran’s nuclear facilities were successful?, site of The Brookings Institution, 24/6/2025, https://www.brookings.edu/articles/how-do-we-know-if-us-strikes-on-irans-nuclear-facilities-were-successful; and Director General Grossi’s Statement to UNSC on Situation in Iran, site of International Atomic Energy Agency (IAEA), 13/6/2025, https://www.iaea.org/newscenter/statements/director-general-grossis-statement-to-unsc-on-situation-in-iran-13-june-2025
[26] Trump has left the G7 early – what are his options for dealing with Iran?, site of British Broadcasting Corporation (BBC), 17/6/2025, https://www.bbc.com/news/articles/cx23e4pzjg3o
[27] Ann Scott Tyson Staff and Fred Weir, Iran relies on China and Russia. They didn’t show up for its fight with Israel, site of The Christian Science Monitor, 26/6/2025, https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2025/0626/china-russia-iran-korea-axis-upheaval; and Jonathan Roll, Where are China and Russia in the Israel-Iran conflict?, site of The Loop, 3/7/2025, https://theloop.ecpr.eu/where-are-china-and-russia-in-the-israel-iran-conflict
[28] وليد عبد الحي، إيران: مستقبل المكانة الإقليمية عام 2020، ص 35-37، وص 550-552.
أ. د. وليد عبد الحي – مركز الزيتونة

بواسطة akhbariran | تموز 30, 2025 | طب وتكنولوجيا
في السنوات القليلة الماضية، أولت الحكومات حول العالم اهتمامًا متزايدًا بالصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، إذ يُقال إنها تقدم لمحة أولى عن شكل حروب المستقبل، ليس فقط من حيث الأسلحة، بل أيضًا من حيث التقنيات والتكتيكات الجديدة.
ومؤخرًا، أظهرت الهجمات الأميركية- الإسرائيلية على إيران ليس فقط إستراتيجيات جديدة في استخدام الطائرات المسيّرة وعمليات التسلل، بل كشفت أيضًا عن ثغرات جديدة. فقد شهدت إيران والسفن في مياه الخليج خلال النزاع الذي استمر 12 يومًا انقطاعات متكررة في إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
وقد أثار هذا الأمر قلق السلطات الإيرانية بوضوح، إذ بدأت بعد انتهاء الحرب بالبحث عن بدائل.
قال إحسان جيت ساز، نائب وزير الاتصالات الإيراني، لوسائل إعلام محلية في منتصف تموز/ تموز: “في بعض الأحيان، تحدث اضطرابات في هذا النظام (GPS) بفعل أنظمة داخلية، وهذا الأمر تحديدًا دفعنا نحو خيارات بديلة مثل نظام “بايدو” (BeiDou)”.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير خطة لتحويل قطاعات النقل والزراعة والإنترنت من الاعتماد على GPS إلى استخدام نظام “بايدو” الصيني.
قد تبدو خطوة إيران نحو اعتماد نظام الملاحة الفضائي الصيني “بايدو” للوهلة الأولى مجرد مناورة تكتيكية، لكنها تنطوي على دلالات أعمق بكثير. فهي تمثل مؤشرًا جديدًا على إعادة اصطفاف كبرى في النظام العالمي.
فعلى مدى عقود، هيمن الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، على البنية التحتية التكنولوجية العالمية، من أنظمة تشغيل الحواسيب والإنترنت، إلى شبكات الاتصالات والأقمار الصناعية.
وقد أدّى هذا الواقع إلى جعل معظم دول العالم تعتمد على بنية تحتية لا تملك ما يوازيها أو ينافسها، مما حوّل الاعتماد إلى مكمن ضعف. فمنذ 2013، كشفت تسريبات وتحقيقات صحفية كيف مكّنت تقنيات وبرامج غربية متعددة من تنفيذ عمليات مراقبة غير مشروعة وجمع بيانات على نطاق عالمي، وهو ما أثار قلق العديد من الحكومات حول العالم.
يشير احتمال تحوّل إيران إلى نظام “بايدو” الصيني للملاحة إلى رسالة واضحة لبقية الدول التي تكافح من أجل الموازنة بين سهولة التكنولوجيا وضرورات الدفاع الإستراتيجي: إنّ عصر الاعتماد الأعمى والساذج على بنية تحتية تتحكم بها الولايات المتحدة يوشك على نهايته.
لم يعد بإمكان الدول ربط قدراتها العسكرية وسيادتها الرقمية الحيوية بشبكة أقمار صناعية تابعة لقوة عظمى لا يمكن الوثوق بها.
ويُعد هذا الشعور أحد الدوافع الرئيسة وراء سعي دول عديدة إلى تطوير أنظمة ملاحة فضائية وطنية أو إقليمية، من “غاليليو” الأوروبي إلى “غلوناس” الروسي، وكلّها تطمح للحصول على حصة في سوق التموضع العالمي، وتقديم ما يُنظر إليه كضمان للسيادة والاستقلال التكنولوجي.
لم يكن نظام GPS الثغرة الوحيدة التي كشفتها الهجمات الأميركية-الإسرائيلية على إيران؛ فقد تمكّن الجيش الإسرائيلي من اغتيال عددٍ من العلماء النوويين والقادة البارزين في أجهزة الأمن والقوات المسلحة الإيرانية.
وأثار نجاح إسرائيل في تحديد مواقع هؤلاء بدقة مخاوف واسعة من احتمال اختراقها شبكات الاتصالات، وقدرتها على تتبّع الأشخاص من خلال هواتفهم المحمولة.
في 17 حزيران/ حزيران، بينما كانت الحرب لا تزال مشتعلة، دعت السلطات الإيرانية الشعب الإيراني إلى التوقف عن استخدام تطبيق المراسلة “واتساب” وحذفه من هواتفهم، مشيرة إلى أنه يجمع بيانات المستخدمين ويرسلها إلى إسرائيل.
وعلى الرغم من عدم وضوح ما إذا كانت هذه الدعوة مرتبطة باغتيال المسؤولين الكبار، فإن الشكوك الإيرانية تجاه التطبيق الذي تديره شركة “ميتا” الأميركية ليست بلا أساس.
لطالما أعرب خبراء الأمن السيبراني عن شكوكهم بشأن أمان تطبيق واتساب. ومؤخرًا، كشفت تقارير إعلامية أن برنامج الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه إسرائيل لاستهداف الفلسطينيين في غزة يعتمد على بيانات تُجمع من وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلاوة على ذلك، تحرك مجلس النواب الأميركي لحظر استخدام واتساب على الأجهزة الرسمية مباشرة بعد انتهاء الهجمات على إيران.
بالنسبة لإيران ودول أخرى حول العالم، فإن الرسالة واضحة: لم تعد المنصات الغربية تُعتبر وسائل تواصل محايدة، بل باتت يُنظر إليها كأدوات في حرب استخبارات رقمية أوسع.
وقد بدأت طهران بالفعل في تطوير شبكتها الداخلية الخاصة، “شبكة المعلومات الوطنية”، التي تمنح السلطات مزيدًا من السيطرة على استخدام الإنترنت. ومن المرجح أن تواصل إيران توسيع هذا المشروع، وربما تسعى إلى محاكاة “جدار الحماية العظيم” الصيني.
من خلال سعيها للانفكاك عن البنية التحتية الخاضعة لهيمنة الغرب، تؤكد طهران اصطفافها ضمن دائرة نفوذ عالمية متنامية تتحدى الهيمنة الغربية بشكل جوهري. وهذا التحالف يتجاوز مجرد التبادل التجاري أو التقني، إذ توفر الصين لإيران أدوات حيوية لتحقيق استقلال رقمي وإستراتيجي فعلي.
السياق الأوسع لهذا الأمر هو مبادرة الحزام والطريق الصينية العملاقة (BRI). فعلى الرغم من تصويرها غالبًا كمشروع بنية تحتية وتجارة، فإن مبادرة “الحزام والطريق” كانت دائمًا أكثر من مجرد طرق وموانئ. إنها خطة طموحة لبناء نظام عالمي بديل. وإيران- بموقعها الإستراتيجي وكونها مورّدًا رئيسيًا للطاقة- أصبحت شريكًا ذا أهمية متزايدة في هذه الرؤية التوسعية.
ما نشهده اليوم هو بروز تكتل تقني قوي جديد: تكتل يربط بشكل وثيق بين البنية التحتية الرقمية وشعور مشترك بالتحدي السياسي. فالدول التي أنهكتها المعايير المزدوجة للغرب، والعقوبات الأحادية، والهيمنة الرقمية الساحقة، ستجد بشكل متزايد في النفوذ المتنامي لبكين مصدر راحة وأداة فعّالة للمناورة.
هذا التحول المتسارع يُنذر ببزوغ فجر “حرب باردة تكنولوجية” جديدة، مواجهة منخفضة الحدة تتجه فيها الدول بشكل متزايد لاختيار بنيتها التحتية الحيوية- من أنظمة الملاحة والاتصالات إلى تدفقات البيانات وأنظمة الدفع المالي- ليس بناءً على التفوق التكنولوجي أو التغطية العالمية الشاملة، بل بناءً على الولاء السياسي والأمن المُتصوّر.
ومع انضمام المزيد من الدول إلى هذا النهج، ستبدأ الميزة التكنولوجية الغربية بالتآكل في الزمن الحقيقي، مما سيؤدي إلى إعادة رسم ديناميكيات القوة الدولية.
جاسم العزاوي – الجزيرة